لقراءة الجزء الأول من نزف الذكريات من هنا
تلك أيام خلت، أكاد أجزم أنها تختلف كثيرا، من حيث أحداثها ومفرداتها، ومن حيث ألوان أطياف أهلها، واهتماماتهم. قبيل بدء العام الدراسي، كانت الأسر تستنفر ما لديها من ” صُررٍ ” فيها القليل القليل من المال المعجون بالعرق والجهد، لشراء مستلزمات المدرسة للعام كله، حيث يبدأ باص القرية ” العتيق ” باستقبال الخطى إلى نابلس، لشراء ( الجزمة الشتوية – ماركة عصفوركو – والبنطال الخاكي، والقميص الأبيض، أو المريول المخطط للبنات ) ولا شيء غيره، ربما كانت أثمان تلك الكسوة لا تتجاوز الدينار الواحد، لكنها كانت تضفي نكهة بدء الحياة على الطلبة. وأذكر أن بدء العام الدراسي، في بداية أيلول، كان يتصادف مع أمطار غزيرة، لذلك كان الحرص على ” الجزمة البلاستيكية ذات الساق العالي “، والتي كان يقدّر لها أن تحمل الأجساد المرتجفة كل صباح إلى المدرسة. لكنها لم تكن قادرة على أداء دورها حين ” يجرّ الكسلان ” !
و”الكسلان” هو الاسم الذي أطلقه الناس عبر العصور على الوادي الذي كان يجري عبر ” باطنة رزّة ” قاطعًا ” الميدان، فبئر العبد ” غربًا إلى ” المربّعة “، ليصب في النهاية في وادي تلفيت. ولعل تسميته ” الكسلان ” جاءت من كونه لا يجري كل عام، فإن جرى أحدث فوضى في الأرض، وفي المشاعر، مع ما يصاحب ذلك من استبشار بموسم زراعي جيد.
كان، وربما لا يزال ” الكسلان ” يعبر من أمام المدرسة الثانوية للبنين، عابرا ملعبها من الشرق إلى الغرب. ولأنه يتعذر على الصغار قطعه بقوتهم الذاتية، فقد كان القائمون على المدرسة،( المدير والمعلمون والآذن ) يضعون الحجارة الكبيرة وسطه، لتتنقل خطى الأطفال عليها، ويتفادون أن تداهمهم المياه، وكان ذلك ينجح حين تكون كمية المياه الجارية عادية، لكن حين كان “يتغوّل” الوادي، كان لا بد من معين، فترى الطلبة الكبار، وأحيانا المدرسين، يقفون وسطه يحملون الأطفال، وينقلونهم عبره، إلى الجهة الأخرى، بالرغم من شدة البرودة، والبلل الذي كان يغرقهم عن آخرهم.
كل هذا لم يكن يشفع للمتأخرين عن جرس الصباح، أولئك الذين كانت تنتظرهم عصا المدير أمام غرفته، ولم تكن زرقة أيديهم وأصابعهم كافية لتشفع لهم، فكنا نتندر – مكابرين – أن الضرب بالعصا على الأكف الصغيرة والأصابع الطرية هو شيء جيد، كونه يبعث فيها الدفء، يدعم ذلك ما كنا نراه من حنان وشفقة، في عيني ( أبو سليمان، وأبو سلطان من بعده – يرحمهما الله ) حيث كانا يتركان لنا فرصة الاصطلاء بدفء النار، التي كانا يوقدانها في برميل، أمام غرفة المدير، بينما لم يكن الحال كذلك عند دخولنا إلى الغرف الصفية، حيث كان ينتظرنا استاذ الحصة الأولى ممتلئًا غضبا علينا، كوننا سنجبره على إعادة ما فاتنا شرحه، ولم يكن ذلك بالمجان، بل بعقاب إضافي، وبعصا إضافية.. ويجب التنبيه هنا، إلى أننا لم نكن نعي ما خلف هذا العقاب، والذي لولاه لما واصلنا الدراسة، ولما كنا على قدر حمل المسؤولية فيما بعد، وأعتقد أن الكثيرين فهموا ذلك، حين كبروا، ووعوا، وصاروا يرون أبناءهم يذهبون إلى المدرسة وفي خطاهم شيء من اللامبالاة!
يتبع…
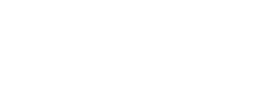 شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة
شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة


الله الله من هنا يسطع قمر الإبداع …. جعلني أسترجع حنين وشوق الدراسة ..جعلني أتخيل ماضيهم الجميل .ماضي أبي وما سبقوه!..حقا وأنا أقرأ أبتسم في سرد الذكريات والأيام الجميلة ! حفظك الله شاعرنا المبدع …كل الأحترام والتقدير