كان عهدي بمدرسة قصرة ( الثانوية ) حين دخلتها ملتحقا بالصف الأول الابتدائي.. ولا أزال أذكر وقفتي الأولى في طابور الصباح، لأنها كانت وقفة لا تُنسى، حيث كنت أقف في أول صف من ناحية الشرق، بينما تمتد الصفوف غربا، حتى تنتهي بالصف الثالث الإعدادي.. وكنت ( والرهبة تملؤني، أسترق النظر إلى هذه الطوابير، فأجدها كثيرة جدا، علما بأنها لم تكن في تعداد طلابها تتجاوز المائة إلا بقليل..
ولا أزال أسمع جرس الصباح، حين دقّ معلنا لحظة الانطلاق إلى الصفوف، فصعدت الخطى الصغيرة والكبيرة، كل في طريقها، عبر درج من الحجارة المرتبة تحيط بها من جانبيها الورود والزهور، بينما اصطفت الفصول في أبّهةٍ عالية الهيبة، وكانت الغرفة الأولى من الشرق يومها هي مقصد الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، حيث يمسك كل طفل بقميص زميله أمامه، كي لا يخرج عن الطابور، بناء على تعليمات الأستاذ المناوب الذي نبه في طابور الصباح، بعد الترحيب بالطلاب، إلى ضرورة المحافظة على النظام في أثناء الصعود إلى الغرف الصفية.
قبل ذلك الوقت كانت مدرسة قصرة ( الثانوية ) مدرسة مختلطة للبنين والبنات، منذ عشرينيات القرن الماضي، ولعل ذلك ينبئ بمدى الوعي بأهمية العلم، والتعلّم.. ففي قرية تختفي نساؤها خلف عباءات سوداء في ذهابهن وإيابهن، لا يمكن لأحد رؤية وجوههن، ولا الحديث معهن، حتى بطرح السلام، كان الآباء والأمهات يقبلون بأن تكون بناتهن في غرفة واحدة مع الطلاب، وأمام مدرسين ذكور.. ربما كان لضيق الحال سبب في ذلك، حيث لا إمكانية لبناء مدرسة مستقلة للبنات، ولكن مجرد قبول فكرة الاختلاط يكفي للحكم على فهم المجتمع لقيمة المدرسة، ودورها في خلق الأجيال الواعية من الجنسين.
كانت المدرسة حين التحقت بها تتكون من سبع غرف صفية، وعليها أن تستوعب الطلاب من الصف الأول الابتدائي، حتى الثالث الإعدادي، وقد أوجب هذا النقص في الفصول أن يتم وضع صفين أحيانا في غرفة واحدة، وأذكر أنني درست الصف الثالث الابتدائي مع زملائي في الصف الرابع في غرفة واحدة، وكذلك كان الحال بين الصفين الخامس والسادس.. وكم كان ذلك شاقًّا، ومفيدًا في آن، حيث كان على المعلم أن يقسم زمن الحصة إلى قسمين، يخصص الأول منه لطلاب الصف الثالث، بينما يوكل لطلاب الصف الرابع أن يحلوا واجبا بصمت مطبق، ويتم تبادل الحال، بعد مرور نصف الزمن.. وهكذا، لذلك وجدتنا في الصف الثالث نحفظ دروس الصف الرابع كلها، وكذلك الخامس مع السادس..
لم يكن هناك أي مبنى آخر، حيث كان مدير المدرسة والأساتذة يجتمعون في غرفة صغيرة كأنها مخزن، تقع أمام الفصول الدراسية، بينما يدور “الآذن” طوال اليوم على أرجاء المدرسة، وفي ساحاتها البسيطة. وكان ما يميّز المدرسة آنذاك حديقتها الجميلة، التي تزخر بأنواع الفاكهة والخضراوات، حيث كان الطلاب يشاركون مشاركة كاملة، بل على عاتقهم تقوم عميلة الزراعة والحراثة والري، وغيرها، وتحديدا في حصتي الزراعة العملي، اللتين كانتا مقررتين رسميا ضمن البرنامج الأسبوعي لتوزيع المواد الدراسية.
في ملعب المدرسة الترابي، كنا نموت شوقا لحصة الرياضة، التي عادة ما تقتصر على الجري في الملعب، والانفلات من رتابة اليوم الدراسي، وضغط الصمت الذي كان يلفّ الفصول الدراسية، حيث كان النظام يقضي بأن تبقى الأيدي متشابكة الأصابع، وموضوعة بإحكام على المقعد الخشبي الطويل، الذي كان يتشارك فيه ثلاثة طلاب، وأكثر أحيانا، بحسب عدد الطلاب في الفصل.. أما كرة القدم الوحيد في المدرسة، فكانت من الجلد الطبيعي، وكانت تزور ( أبو جميل ) باستمرار لخياطتها وإصلاحها، أو رقع بالونها، قبل كل مباراة داخلية، أو خارجية، حيث كان فريق قصرة الرياضي لكرة القدم من الفرق التي لها سمعتها، وقيمتها على مستوى محافظة نابلس..
… يتبع
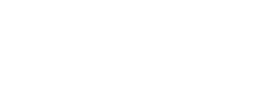 شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة
شبكة قصرة نت | موقع قرية قصرة






شكراً لك أيها الشاعر الجميل على ما خطته يمناك … لقد أرويت ظمأنا لهذا النوع من الكتابة … فلتنزف ذاكرتك كل ما يعتمل فيها من أفكار وصور … لعلنا نقرأ شيئاً مثل رأيت رام الله لمريد البرغوثي أو منازل القلب لفاروق وادي أو تمر حنة لرشاد أبو شاور
مقال جميل جدا من زميل الطفولة الاخ الشاعر هلال الفارع وهنا لا بد من التذكير بان المدرسة الاولى التي تأسست في البلد في بدايات القرن التاسع عشر كانت جنب الجامع الكبير وسط البلد واما المدرسة الغربية فقد ابتدأت بغرفتين فقط وتطورت فيما بعد عبر السنين.
لا اذكر انها قبل 1967 كانت مختلطة وعلى دور جيلنا . بداية ، البنات كانوا يدرسوا في المدرسة الملاصقة لمقام الشيخ ناصر منصور الذي تم ازالته حينما تم التوسعة الكبيرة للمسجد للاسف الشديد فان مكانه الان دورة المياه التابعه للمسجد وهذا شي مؤسف بحد ذاته الم يكون بالاجدر الاحتفاظ به كرمز تاريخي للبلد واحترام لموتانا!!
وفي هذه العجاله لابد ان اذكر ان هذا الصرح العلمي لقصره كان وسيبقى مكان احترام لكل من درس فيه وعمل فيه من الاجيال السابقه واللاحقة لقد تخرج من هذه المدرسه الالاف سواء من ابدعو في مختلف نواحي العلوم الانسانيه من ابناء قصره وكذلك القرى المجاوره وهنا لابد انا اذكر بالذات اهالي ( دوما ) الكرام وكذلك لا ننسى اهلنا واحبتنا من (جوريش ) الى (تلفيت ) و ( مجدل بني فاضل)
عودة على بدء يشرفني ان اذكر واتذكر بكل فخر تلك النخبة من المدرسين الاوئل امثال الاستاذ هاشم عوض الوادي (ابو ايمن ) اطال الله في عمره وهنا يطيب لي ان اقترح ان يتم اجراء مقابله مطوله معه عن تاريخ المدرسه ونشأتها موثقا بالصوره والكتابه لانه سوف يكون مرجع بحد ذاته لاجيال المستقبل وانا واثق بان ابو ايمن لن يبخل في هدا المجال.
لابد لي انا اتذكر الاستاذ المرحوم سامي عبد القادر (ابو خالد ) رحمه الله وكذلك الاستاذ عادل من جوريش والاستاذ عبد القادر التلفيتي ولا زلت اذكر ايضا بعض الاسماء مثل ابو بسام وهو من طوباس وكذلك الاستاذ داود وهو مدرسنا في مادة الرياضيات واذكر انه كان محبوبا من قبل الطلاب ولكن من ناحيه اخري كان هناك استاذا على ما اعتقد انه من منطقة الخليل واسمه الاستاذ فضل كان يتفنن في استعمال “مطرقت” الرمان و “الفلكه” واعتقد انه هذه الاساليب انتهت ولا رجعه لها في كلا الحالتين نقول سامحه الله سامحه الله هل كانت هذه الوسيله المثلى لتنشأ الاجيال ؟
ونأمل من الله ان ياتي اليوم الذي نحتفل به في مرور مئة عام على انشاء هذه المدرسه احتفالا يليق بهذا المنار العلمي الذي نفخر به جميعا
تحيه لكل شباب قصره القائمين على هذا الموقع
ابن قصره البار الدكتور مازن ابو رزق لندن
26 ايار 2013
العزيز الوفي د. مازن رزق حفظك الله
أسعدتني مداخلتك كثيرا، وأعادتني إلى أيام زاهية الألوان، غالية على معنى الإنسان..
نعم صحيح ما أشرت إليه من أن المدرسة كانت غرفتين، ثم تطورت، مثلما هو صحيح أيضا أن مدرسة البنات كانت في” ناصر منصور “، لكنني عند بدء كتاية في هذه الذكريات، قمت بالتحدث مع الشباب الرائع القائم على الموقع، وعلى أمر هذا الفضاء الجميل برمته للبلد العزيزة، وسألتهم أن يطلبوا من الجيل الذي سبقنا، والجيل الذي سبقهم، للحديث عن البدايات، فهم بها أدرى وألصق، وسيكونون أصدق وأوثق.. لكن لم يحصل شيء من ذلك حتى الآن.
أما بالنسبة للاختلاط في المدرسة، فقد كان موجودًا حتى أواسط، وربما نهاية الخمسينات من القرن العشرين، وربما فصل بيننا وبين ذلك العهد خمس سنين أو أقل..
على أية حال، حين طرحت فكرة الكتابة في هذا الأمر، كان الهدف توثيق بعض ما كاد يضيع، ومحاولة استعادة ما ضاع من الحياة الفطرية النقية التي سادت زمنا ليس بالقليل.. كم أتمنى لو جمع التراث، وجمعت المعلومات من الأذهان، وكتبت الحوادث والسير قبل أن ندسها في التراب! كم من المفردات الحياتية، والموجودات العينية دفنت مع جهلنا بقيمتها.!!
يا صديقي لك التحية والشوق، وكل الاحترام والمحبة.. ردّك الله سالما غانما، وجعل لقاءنا قريبا.. رمضان مبارك عليك وعلى عائلتك.. وكل عام وأنتم بخير
أخك: هلال الفارع